ن “اقتصاد الكفاءة” إلى “اقتصاد الأمن”… العالم يتبدّل والنظام العالمي يُعاد تشكيله
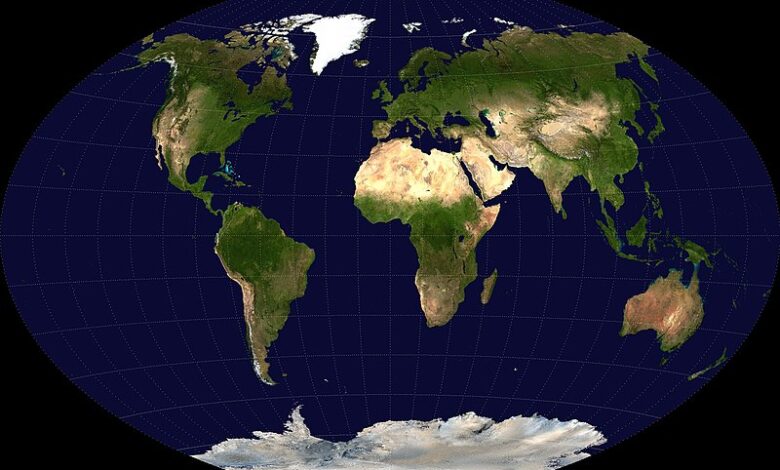
/Mercator projection of Earth from NASA’s Earth Observatory “Blue Marble” series.
نيويورك – خاص – زينة بلقاسم
ليست حركة الأسواق بين ارتفاعٍ وحيادٍ ثم هبوطٍ مجرّد مزاجٍ عابر، بل هي لغةٌ مالية تُترجم صراعًا أعمق على قواعد اللعبة الدولية، فمَن يملك سلاسل الإمداد، ومَن يسيطر على التكنولوجيا الحرجة، ومَن يؤمّن الطاقة والغذاء والتمويل، وكيف تُدار المخاطر حين تختلط السياسة بالاقتصاد. ومن هنا يبدأ الفهم الاستراتيجي بأن العالم لا يُعاد تشكيله بخطةٍ واحدة تُكتب في غرفةٍ مغلقة، بقدر ما يُعاد تشكيله بتراكُم خطواتٍ معلنة، نجحت أحيانًا وأخفقت أحيانًا أخرى، واتخذتها دولٌ كبرى وتكتلاتٌ اقتصادية وشركاتٌ عابرة للحدود، ثم قامت الأسواق بتسعير آثارها فورًا، كأنها لجنةُ تحكيمٍ لا تُصوّت بالكلام بل تُصوّت بالأسعار وكلفة التمويل.
ولكي يكون السردُ مؤسَّسًا لا إنشائيًا، فمصادر المعرفة هنا ليست حدسًا شخصيًا بل هي ما يتكرر في تقاريرٍ وبياناتٍ وتصريحاتٍ معلنة من مؤسسات دولية، وما تنقله وكالاتٌ إخبارية كبرى بوصفه تصريحاتٍ منسوبة لمسؤولين ومحللين، وما يكتبه باحثون ومعلّقون على منصات أكاديمية وصحافية. في هذا الإطار، يقدّم صندوق النقد الدولي صورةً عن اقتصادٍ عالمي يتحوّل تحت ضغط صدماتٍ متلاحقة وتبدّلٍ في السياسات، حيث يقدّر تباطؤ النمو العالمي من ٣،٣٪ في سنة ٢٠٢٤ إلى ٣،٢٪ في ٢٠٢٥ ثم ٣،١٪ في ٢٠٢٦، مع تأكيدٍ على أن المخاطر تميل للهبوط في بيئةٍ أكثر تجزؤًا وعدم يقين. وفي المقابل، يلفت مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن التجارة العالمية بلغت في عام ٢٠٢٤ مستوى قياسيًا قُدّر بنحو ثلاثة وثلاثين تريليون دولار، لكنه يحذّر من مخاطر جديدة تلوح”بسبب التوترات الجيوسياسية وسياساتٍ تتغير وتوسّع الفجوة بين الاقتصادات.  هذا التعايش بين تجارةٍ كبيرة ومخاطرٍ أكبر هو ما يفسّر لماذا قد تبدو الأسواق أحيانًا متناقضة: فهي لا تبحث عن “قصة واحدة”، بل تُسعّر احتمالاتٍ متعددة في الوقت نفسه.
ومن أجل فهم كيف وصلنا، لا بد من استدعاء تاريخٍ قريب لخطواتٍ نجحت وخطواتٍ فشلت. فبعد عقودٍ من بناء نظامٍ اقتصادي دولي واسع بعد الحرب العالمية الثانية، ترسخت فكرة أن الاعتماد المتبادل والتجارة سيقللان دوافع الصراع، وأن معيار الكفاءة (أي الأقل كلفة) هو المعيار الأعلى. وقد نجحت هذه القاعدة طويلًا حيث توسعت سلاسل الإمداد، وتراجعت كلفة الكثير من السلع، وارتفعت أرباح الشركات العابرة للقارات. لكنها زرعت في الوقت نفسه هشاشةً مُضمرة: حين تتركّز حلقات حاسمة في أماكن قليلة، يصبح تعطّلها أو استهدافها قادرًا على شلّ صناعاتٍ كاملة.
ثم جاءت الأزمة المالية العالمية لتُظهر وجهًا آخر للتاريخ إذ يمكن للأسواق أن تُسعّر المخاطر خطأً لسنوات ثم تُصحّح بعنف. تم إنقاذ النظام المالي في دولٍ عديدة، لكن الإصلاح الاجتماعي لم يمشِ بالسرعة ذاتها، فازداد الاستقطاب السياسي والحمائية تدريجيًا. بعد ذلك، جاءت جائحة كورونا لتضيف طبقةً ثالثة من الدروس تفهم على أسس بأن المخاطر ليست كلها مالية فبعضها صحيٌّ يشلّ الموانئ، ويعطّل المصانع، ويكشف أن الكفاءة الشديدة قد تتحول إلى هشاشة شديدة. هنا بدأت مفردات مثل المرونة والمخزون الاستراتيجي وتنويع الموردين تنتقل من تقارير تقنية إلى صلب خطاب الحكومات والشركات، ثم تحولت إلى قرارات فعلية تتمث في نقلٌ جزئي للإنتاج و عقود توريد طويلة وتفضيل موردين أكثر موثوقية ولو بكلفة أعلى.
وعندما ارتفعت الأسعار وظهر التضخم بقوة، عادت البنوك المركزية إلى الواجهة لأن الفائدة عندما ترتفع تعيد تسعير كل شيء، من العقار إلى الأسهم إلى عملات الأسواق الناشئة، فتبدأ موجة إعادة تشكيل ثانية داخل الاقتصاد نفسه. ومع تراكب هذه الطبقات الاقتصادية فوق طبقة الجغرافيا السياسية، صار الحديث عن “إعادة تشكيل العالم” أكثر وضوحًا كانت بدايتها الحرب في أوكرانيا وما ارتبط بها من عقوبات وتحوّلات في تجارة الطاقة عمّقت فكرة أن الأدوات الاقتصادية أصبحت أدوات أمن قومي، وأن الطاقة والغذاء والتمويل لم تعد ملفات سوق فقط بل ملفات قدرة و ضغط.
ومن هذه النقطة ينتقل السرد بسلاسة إلى السؤال: من يقرر إعادة التشكيل؟ فتبدأ الإجابة الاستراتيجية بالاعتراف بأن المقرِّر ليس جهة واحدة بل منظومة قرار متعددة المستويات: دولٌ كبرى تمسك بمفاتيح التكنولوجيا والتمويل، وتكتلاتٌ تملك قواعد سوقٍ ضخمة تستطيع تحويلها إلى قوة تفاوض، وشركاتٌ كبرى تتحكم في أجزاء حساسة من سلاسل الإمداد والمعرفة، وأسواقٌ تحدد كلفة المال ووجهته فتُسرّع أو تُبطئ أي مسار. ولذلك، حين نسمع عن خطط ومخططات، فالأدق غالبًا أن نتحدث عن استراتيجيات متنافسة تتقاطع وتتصادم: استراتيجية لتأمين سلاسل الإمداد، وأخرى لحرمان الخصم من تقنية حرجة، وثالثة لفرض قواعد تصدير واستثمار، ورابعة لتأمين الطاقة والمواد الخام.
وفي قلب هذا النقاش يظهر مصطلح ما يُتدَاول بأنه “الفوضى الخلّاقة”. هنا يلزم تمييزٌ ضروري حتى لا تختلط المعاني عمدًا أو سهوًا. فهناك مفهوم اقتصادي معروف باسم الهدم البنّاء أو التدمير الخلّاق، ارتبط بعالم الاقتصاد “جوزيف شومبيتر” الذي شاع عنه هذا التعبير في كتابٍ صدر في عام ١٩٤٢ بوصفه وصفًا لديناميكية الابتكار التي تهدم القديم وتخلق الجديد داخل الاقتصاد. لكن ليست الفوضى الخلّاقة في الخطاب السياسي، نظرية اقتصادية بقدر ما هي سردية جيوسياسية تقول إن خلق اضطرابٍ أو السماح له بالاتساع قد يفتح الطريق لإعادة تركيب نظامٍ سياسي أو إقليمي بصورةٍ جديدة تخدم مصالح قوةٍ كبرى أو تكتلٍ ما.
واذا سألنا عمن اعتمدها؟ تكون الاجابة في الاستخدام السياسي الشائع، و تُنسب هذه السردية بكثرة إلى بيئة “المحافظين الجدد” في الولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من أيلول، وإلى خطابٍ رافق الحديث عن شرق أوسط جديد. وفي هذا السياق، نقلت منصات تحليلية وصحافية أن وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك “كوندوليزا رايس” وصفت تصاعد العنف خلال حرب لبنان وإسرائيل بأنه آلام مخاض شرق أوسط جديد، وهو تعبيرٌ صار عند كثير من المعلقين مرادفًا لفكرة أن اضطرابًا كبيرًا قد يكون بوابةً لواقعٍ جديد. وفي المقابل، توجد كتابات عربية متعددة تُرجع جذور المصطلح أو دفعه الفكري إلى أسماء مثل “برنارد لويس”، لكن هذا الإسناد ليس محل إجماع علمي واحد، وغالبًا ما يرد في سياق مقالاتٍ وتأويلاتٍ سياسية أكثر من كونه عقيدة رسمية مكتوبة في وثيقة حكومية واحدة.  لذلك، الأكثر دقة أن نقول أنّ الفوضى الخلّاقة، ليست قرارًا مُوقّعًا بمرسوم، بل إطارٌ تفسيري استخدمه محللون وكتّاب، وأحيانًا استُحضر لتأويل خطاب مسؤولين وسياساتٍ على الأرض.
واذا سألنا كم مرة اعتُمدت؟ فالإجابة تكون أنه لا يوجد عداد رسمي يُحصي تطبيقها، لأن المسألة ليست برنامجًا مُعلنًا بعنوان واحد، بل نمط قراءة تُقرأُ بهذه الطريقة:هل سمحت قوةٌ كبرى بانفلاتٍ أو ساعدت على تفكيك نظامٍ دون بديل مستقر؟ هل اعتبرت انهيار القديم فرصة لصياغة جديد؟ لهذا نجد من يستخدم المصطلح للإشارة إلى محطات متعددة في الشرق الأوسط منذ مطلع الألفية الثالثة، لكن اختلاف الوقائع وتعدد الفاعلين يجعل الحديث عن عدد مرات محددًا أمرًا أقرب للجدل منه للقياس الدقيق.
واذا تبادرت لنا الاسئلة: هل نجحت؟ وهل فشلت؟ تكون لنا قدرة محدودة في توفرإجابة واقعية: إذ يُقال انها نجحت جزئيًا في تفكيك بعض الترتيبات القديمة، لكنها كثيرًا ما فشلت في إنتاج نظامٍ جديد مستقر بالكلفة الأقل. ففي الحالات التي يُشار إليها عادةً، على اختلاف تقييم الناس لها، كان التغيير السريع أسهل من بناء الدولة أو بناء التوافق أو إعادة الإعمار المؤسسي. بمعنى آخر: إذا كان الهدف المعلن في بعض الخطابات هو “إعادة ترتيب المنطقة”، فالتاريخ أظهر أن خلق الفراغ قد ينتج قوى محلية وإقليمية غير متوقعة، وقد يطيل أمد الصراع بدل اختصاره، وقد يرتد على الاقتصاد العالمي عبر موجات لجوء، وتذبذب طاقة، وتوتر ملاحة، وتنامي مخاطر الإرهاب. وهذا هو جوهر المفارقة: الفوضى قد تكون أداة لإسقاط واقع، لكنها نادرًا ما تكون أداةً دقيقة لبناء واقعٍ أفضل على مقاس من أطلقها أو راهن عليها.
وهل تُطبّق الآن من طرف قوة كبرى لفرض نظامٍ وواقعٍ جديدين؟ إذا أخذنا المصطلح حرفيًا بوصفه خطة متعمدة لصناعة الفوضى، فالإثبات الصلب أصعب لأن القوى الكبرى اليوم تتجنب إعلان ذلك كسياسة، بل تميل إلى لغة إدارة المنافسة و خفض المخاطر و الأمن الاقتصادي. لكن إذا أخذناه بوصفه نمَطَ ممارسة، أي استخدام الضغوط الاقتصادية، والحروب بالوكالة والعقوبات وإعادة تسليح الاعتماد المتبادل وترك بؤر توتر تتوسع ما دامت لا تُهدد المركز مباشرة فإن عناصر شبيهة تظهر في أكثر من مسرح. و بمعنى عملي: قد لا تُسمّى “فوضى خلّاقة” في البيانات، لكنها قد تُمارَس كواقعٍ حين تُدار الأزمات بحيث تُنهِك خصمًا، أو تُعيد توجيه تحالفات، أو تُجبِر دولًا أصغر على التموضع داخل تكتلات جديدة.
وهنا نعود بسلاسة إلى السؤال الأوسع: على ماذا تُبنى التحالفات والتنازلات والتضحيات؟ إنها تُبنى اليوم على خمسة معايير صلبة أكثر من أي وقت تتمثل في نقاط الاختناق وحساسية التضخم الداخلي والقدرة الصناعية والدفاعية والديون وكلفة الاقتراض والشرعية الاجتماعية. و بالتالي من يملك عقدةً في شبكة الإمداد أو في التقنية أو في الطاقة يملك نفوذًا تفاوضيًا ومن يعتمد على عقدةٍ لدى طرفٍ آخر يصبح عرضة للضغط. ولهذا تتغير التحالفات حول الممرات البحرية، وحول صفقات الغاز والنفط، وحول الاستثمار في الموانئ والسكك الحديدية، وحول اتفاقات توريد المعادن الحيوية. وفي هذا كله، تبقى الأسواق حاضرة لا بوصفها مرآة فقط بل محركًا: فهي تسعّر المخاطر لحظةً بلحظة، وتوزع رأس المال على الصناعات التي يراها المستثمرون مدعومة سياسيًا وواعدة اقتصاديًا، وتفرض انضباطًا قاسيًا على الحكومات التي تُربك التمويل بسياسات مالية غير قابلة للاستمرار.
ومن داخل هذا المشهد يمكن فهم سؤال هل سيقبل العالم؟ على أنه سؤال تكيّف لا تصويت. فالعالم لا يجتمع ليوافق على نظام؛ بل يتكيف بحسب قوته وهشاشته. والأضعف في المصير، كما يبين من تجارب الأزمات المالية والغذائية والطاقة، ليس بالضرورة دولةً فقيرة فقط، بل دولةٌ أو اقتصادٌ محاصرٌ بثلاثة قيود معًا هي اعتماد كبير على استيراد الغذاء أو الطاقة و مديونية مرتفعة بعملةٍ لا يطبعها ومؤسسات ضعيفة في إدارة الصدمات. مثل هذه الاقتصادات تتلقى الضربة ثلاث مرات عندما تتغير قواعد العالم: إذ ترتفع فاتورة الواردات وترتفع كلفة الاقتراض وتُجبر على تنازلاتٍ في السياسة أو الاقتصاد لاستعادة التمويل أو الإمدادات. وفي المقابل، يظهر الهامش عند من يملك موارد طاقة، أو موقعًا لوجستيًا، أو سوقًا كبيرة، أو قدرةً صناعية، أو مؤسسات مالية قوية.
أما ما قد يأتي بعد ذلك، فالأقرب أنه ليس مسارًا واحدًا بل ثلاثة مسارات تتعايش بدرجات متفاوتة. مسار “تعدد أقطاب مُدار” حيث التكتلات تتنافس لكنها تُبقي خطوط التجارة والمال مفتوحة بالقدر الذي يمنع الانهيار، ومسار تجزؤ صادم إذا وقعت صدمة كبرى في ممرات بحرية أو طاقة أو تقنية وأتبعتها موجة تضخم وتشدد مالي وأزمات ديون، ومسار صفقات موضعية ليست سلامًا شاملًا بل تفاهمات في نقاط اختناق محددة لأن كلفة الفوضى تصبح أعلى من مكاسب التصعيد. وفي كل هذه المسارات ستظل الأسواق تؤدي دور الحكم الذي لا يصفّق ولا يندد، بل يرفع كلفة القرار أو يخفضها فقط ويعطي إشارة مبكرة عمّا إذا كان العالم يتجه نحو استقرارٍ مُدار أم نحو فوضى تتسع ثم تحاول القوى الكبرى إدارتها بعد أن تفلت من يدها.


